أحمد آدم
اسم الكتاب: الانتفاضات المدنية في السودان الحديث
المؤلفة: ويللو بيريدج*
الناشر: منشورات بلومسبري – لندن/نيويورك
تاريخ النشر: 2015

ي كتابها الصادر عن منشورات بلومسبري، ترى الباحثة ويللو بيريدج أن ثورة أكتوبر 1964 في السودان مثلت حدثاً فريداً، إذ تحدت فرضيتين كانتا مهيمنتين وسط الباحثين. الفرضية الأولى أن الأنظمة في الشرق الأوسط وأفريقيا لا يمكن إزاحتها سوى بانقلاب عسكري، والفرضية الثانية أن الأحزاب السياسية في هذه الدول لم يكن لها دور مؤثر في النصف الثاني من القرن العشرين
تقدم بيريدج في كتابها هذا تحليلاً دقيقاً للظروف التي جعلت السودان قادراً على إنتاج هاتين الظاهرتين السياسيتين الفريدتين، أي ثورتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985. مُشيرة لسلمية المظاهرات في أكتوبر، وقائلة إن ما يثير الاهتمام هي هتافات الثورة غير الدينية، رغم وجود قيادات ضمن الثورة أصبحوا فيما بعد قادة الإسلام السياسي في السودان. وذهبت لتحليل هذه الظاهرة، بالنظر للكيفية التي فسرت بها النخبة المتعلمة ثورة أكتوبر كحدث قومي، لذلك تم تجاوز الفروقات الأيديولوجية بين المتظاهرين مؤقتاً من أجل الهدف الرئيسي، وهو إسقاط نظام عبود
بدأ نظام إبراهيم عبود، لأول مرة في السودان، الاعتقال التحفظي ومنع أي أنشطة سياسية لا تدعم توجهاته، كما تقول الكاتبة. وأضافت أن عبود لجأ للإكراه والقمع للبقاء، بسبب ضعف قاعدته الجماهيرية، إذ تم إعدام مجموعة من سلاح المشاة في ديسمبر 1959 لمحاولتهم الانقلاب على النظام، وحُلت في عام 1961 نقابة السكة حديد السودانية، وتم إغلاق جامعة الخرطوم نتيجة للمظاهرات التي قام بها الطلبة
وتقول الكاتبة إن المقارنة بين ما فعله عبود وما فعله نميري والبشير من بعده تكاد تكون معدومة، لكن تلك الأحداث كانت بدعة سياسية في زمنها. فإطلاق الرصاص على الطالب أحمد القرشي، والذي أتى كجزء من مواجهات طويلة بين طلاب جامعة الخرطوم والعسكر، كان حدثاً محفزاً، سرعان ما قاد للمظاهرات التي أدت في النهاية لاقتلاع النظام. وتقول أيضاً إن هناك وجهات نظر مختلفة تم تقديمها لتفسير السقوط السريع لنظام عبود، فثمة من يقول إنه ورغم المظاهرات الضخمة جداً التي أعقبت استشهاد القرشي، لم يكن سقوط النظام مضموناً، ولكن الشيء الذي عجل بنهاية النظام هو إعلان العصيان العام
وثمة من ذهب إلى أن سقوط النظام بسبب الضغط الذي قوبل به عبود من “الضباط الأحرار”، في الوقت الذي يعتقد فيه آخرون أن الجنرال العجوز قرر الاستقالة من تلقاء نفسه لزهده في السلطة. لكن الكاتبة تقول إنه “يجب أن نضع في الاعتبار أن عبود لم يستسلم مباشرة، فالقرار الأول الذي قام به كان إلقاء القبض على اثنين من القضاة الذين شاركوا في المظاهرات التي أدت لإعلان العصيان المدني”. وتعلق على سلمية الثورة بقولها: “إن ثورة أكتوبر نجحت وبشكل كبير في تبني استراتيجية غير عنيفة، لكن من الصعب تصنيفها كثورة سلمية بشكل مطلق. إذ أخذت الثورة طابعاً عنيفاً في منعطفات رئيسية، ولا يمكن أن نقول إن العنف هو الذي لعب الدور الحاسم في إجبار النظام على التنازل عن السلطة. فقيادات الثورة من الأحزاب السياسية، النقابات، والمهنيين، لم يشجعوا استخدام العنف ضد النظام ومنسوبيه، ربما يعود ذلك إلى أنهم يأتون من نفس الخلفيات الاجتماعية ذات الامتيازات التي أتى منها نظام عبود، وليس من مصلحتهم تشجيع أي نوع من أنواع الفوضى التي تؤدي إلى العنف”
في الفصل الثاني المعنون (انتفاضة 1985: هل دمر نميري نفسه؟)، تعود الكاتبة لبدايات ثورة مايو، ناظرة لانقلاب جعفر محمد نميري في 1969 كنتيجة لإخفاقات ثورة أكتوبر، وفشل النظام البرلماني الذي تم تأسيسه في تبني أي استراتيجيات سياسية تقدمية، بالإضافة لعدم قدرته على تحقيق السلام في الجنوب. ثم تستعرض التاريخ الدموي لنظام نميري في السبعينيات، والذي تمثل في الإعدامات السياسية، وأحداث الجزيرة أبا، وغيرها. قائلة إن الطبيعة الدموية للنظام ساهمت في تأخير الانتفاضة عليه، وتعزو الانتفاضة للأزمات المتلاحقة التي حاقت بالنظام حتى منتصف الثمانينيات
وقد كانت الأزمات الاقتصادية في جزء منها نتيجة لعوامل خارجية، مثل: ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الطلب على موارد السودان الخام، بالإضافة لضغوطات صندوق النقد الدولي لإجبار الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط على تبني سياسات اقتصادية تقشفية. ولكن التدهور كان أيضاً بسبب عوامل داخلية، مثل الفساد والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي ركزت على إنشاء مشاريع تنموية ضخمة وطموحة، دون وجود رأس المال الكافي لتسييرها، وفي نفس الوقت تَجاهُل المشاريع الزراعية الموجودة أصلاً، ليمنع هذا التدهور الاقتصادي الحكومة من القدرة على التعامل مع المجاعة التي حدثت بين 83 و 85. إذ رفض نميري الاعتراف بها، وقد مات بسببها الآلاف ونزح مثلهم إلى الخرطوم، ليواجهوا بـ (كشات) أمن نميري لإجبارهم على العودة إلى مناطقهم
تَخَلُص الكاتبة إلى أن التدهور الاقتصادي هو الذي أشعل شرارة الانتفاضة التي أدت لسقوط النظام، يضاف إلى ذلك عدم قدرة نميري على التعامل مع ثورة الجماهير، وأيضاً فقدانه لكل حلفائه السياسيين، بعد أن أصبح نظام نميري نظام الرجل الواحد، بالإضافة لتدهور صحته، والذي جعله غير قادر على اتخاذ قرارات سليمة. على سبيل المثال، إعلان الشريعة وما صاحبها من أحداث، كإعدام الأستاذ محمود محمد طه. لتقول: “ربما يكون نميري هو الذي ساهم في إسقاط نفسه، ولكن الأحزاب السياسية، النقابات المهنية، والاتحادات الطلابية، هي التي حددت الطريقة التي سقط بها، بعد أن قامت بالتنسيق فيما بينها لاستعادة الديمقراطية”. تلاحظ الكاتبة أن الخطاب الديني ظهر بصورة أوسع في انتفاضة أبريل 1985 مقارنة بأكتوبر 1964، بعد أن وضع نميري الدين في مركز الحياة السياسية، وذلك بإعلانه الشريعة الإسلامية، الأمر الذي أجبر المعارضين على انتقاده من وجهة نظر دينية
وفي تحليلها للبنية الاجتماعية لقوى الانتفاضة، ترى الكاتبة أن الانتفاضة احتضنت أعداداً كبيرة من الطبقات الاجتماعية التي تأثرت بشريعة نميري، مع الوضع في الاعتبار أن الخرطوم شهدت درجة كبيرة من النزوح خلال الـ (21) سنة التي تلت ثورة أكتوبر. فمجموعة من شهداء الانتفاضة كانوا من مناطق مهمشة في الخرطوم، مثل مايو والحاج يوسف، وهي الأحياء التي شهدت، في غالبها، هجرات من الهوامش السودانية نتيجة للجفاف والمجاعة والحرب في مناطقهم
وكانت النخبة الحاكمة قد أطلقت تسميات تحقيرية لوصف سكان المناطق (العشوائية) بالقول إنهم (شماسة)، كما استهدفتهم حكومة مايو بشكل منظم في سنواتها الأخيرة، عبر ما سموها حملة (الانضباط العام) للقبض على (العطالى) في مناطق الخرطوم الطرفية وإرسالهم إلى مناطق الزراعة. وقد خرج هؤلاء بأعداد كبيرة خلال الانتفاضة، وساهموا في سقوط نميري، لكن لم يكن هناك أي تمثيل لهذه الفئة الاجتماعية المدينية الجديدة في قيادة الانتفاضة، بالرغم من أن بعض قادة الانتفاضة كانوا متعاطفين بصدق مع مأزق سكان (العشوائيات) لكنهم لم يستطيعوا أن يخلقوا تضامناً صادقاً معهم، وأن الشيوعيين السودانيين كانوا ماركسيين كلاسيكيين، ولم يكن بمقدورهم قبول أن هذه الكتلة البروليتارية المدينية المحرومة، يمكن أن تكون طبقة ثورية محتملة، ولم يكن قادة الانتفاضة من الطبقة الوسطى قادرين على ردم الهوة بينهم وبين ثوار (العشوائيات) سوى بشكل سطحي فقط. بهذا المعنى، وبالرغم من أن الانتفاضة احتضنت أناساً من خلفيات اجتماعية ومناطق جغرافية متباينة أكثر من ثورة أكتوبر 1964، لكن الانتفاضة أعادت إنتاج عدد من إخفاقات أكتوبر
في الفصل الثالث المعنون (الشيوعيون، الإسلاميون، البعثيون، والطائفيون: الأحزاب السياسية في 1964 و 1985)، تتناول الكاتبة دور الأحزاب السياسية، قائلة إن الباحثين في شؤون الشرق الأوسط يجادلون بأنه لم يكن هناك دور مؤثر للأحزاب السياسية في النصف الثاني من القرن العشرين على مستوى دول الإقليم. وينطبق نفس الحال على المحللين في الشؤون الأفريقية الذين يقولون إن الأحزاب السياسية كظاهرة لم تحدث سوى بعد الموجة الليبرالية في 1990. لكن الكاتبة ترى أن ثمة عوامل يجب وضعها في الاعتبار قبل أن نقلل من دور الأحزاب السياسية في السودان، مثل أن الانتفاضتين نجحتا في إعادة ديمقراطية حزبية تعددية، ولو أنها كانت لفترة قصيرة، وهذا يعني أن الأحزاب السودانية لم تغب لفترة طويلة من الممارسة السياسية كرصفائها من دول الإقليم، بالإضافة إلى أن النظامين العسكريين اختارا في فترات من حكمهما أن يشركا بعض من الأحزاب السياسية في السلطة، مما جعلها مواصلة في التأثير في الحياة السياسية. وتقول إن التحليل الدقيق لانتفاضة 64 و 85 يوضح الفرضية الخاطئة أن اليسار، وخصوصاً الحزب الشيوعي، كان القوة الأكثر تأثيراً، فهو لم يكن الحزب الأكثر تأثيراً في جامعة الخرطوم، وهي المؤسسة التي احتضنت ثورة أكتوبر، كما تفند ادعاءات بعض مناوئي الحزب الشيوعي في أنه كان ضد أكتوبر، وقد وضع دعمه الثقيل خلف الثورة عندما اندلعت المظاهرات، فكان ضمن مجموعة متنوعة من الأحزاب والقوى الاجتماعية المختلفة التي دفعت الانتفاضة إلى الأمام. لتضيف أن قوة الحزب الشيوعي في 1964 كانت أكبر منها في 1985 لأنه كان لا يزال يعاني من ضربات نميري المتلاحقة، بينما كان البعث هو الحزب العلماني الذي ساعد في تحريك المعارضة بشكل كبير في 1985، وذلك لأن الحزب كان مدعوماً بشكل مباشر من حزب البعث العراقي
وبالنسبة للأحزاب المحافظة التي تبني شرعيتها على شكل أو آخر من الإسلام السياسي، سواء أكان إسلاماً متجذراً تاريخياً مثل الختمية والأنصار، أو إسلاماً حديثاً مثل الإخوان المسلمين. ترى الكاتبة أن هذه الأحزاب ساهمت بدرجات مختلفة في تحريك المعارضة في الانتفاضتين، وتقول: “بالرغم من دور الإخوان المسلمين في اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في أكتوبر 1964، ولكن لا يمكن أن نقول إن أي من هذه الأحزاب خلق ثورة أكتوبر. لكنها كلها، كما في حالة الحزب الشيوعي، لعبت دوراً مهماً في دعم المظاهرات عند اندلاعها”. وتشير إلى أنه في أكتوبر 64 تحالفت قوى سياسية مختلفة حتى تمت الإطاحة بالنظام، على العكس من أبريل 1985 عندما كانت هناك دلائل كثيرة تشير إلى الانقسام بين القوى السياسية، خصوصاً أن تنظيم الجبهة الإسلامية القومية كان حليفاً أساسياً لنميري قبل سقوطه بأسابيع
في الفصل الرابع المعنون (القوى الحديثة: الطلاب، المهنيون، والنقابات العمالية في 1964 و 1985)، تقوم الكاتبة بتحليل المؤسسات المختلفة المرتبطة بالقوى الحديثة، قائلة إن طلاب الجامعات والمدارس الثانوية هم من أشعلوا شرارة الثورة، ولكن الخريجين المهنيين هم من أعطى الثورة شكلها، بمشاركة نقابات العمال التي جاءت متأخرة نسبياً في الحراك. وتعزو ذلك إلى أن نقابات العمال الرئيسية كنقابة السكة حديد وتجمع مزارعي مشروع الجزيرة كانوا في المدن الإقليمية، وبعيدين عن مكان اندلاع الثورة. في حين أن دور المهنيين فرضه وجودهم في حيز الحدث، فالمحاضرون في الجامعة كانوا قريبين من الطلاب عند اندلاع الثورة، والدكاترة انضموا في لحظة وصول القرشي إلى المستشفى، والقضاة والمحامون كانت مراكزهم في الخرطوم. لتقول إن التمثيل المكثف للمهنيين لا يعطي صورة عادلة عن مشاركة العمال في المدن، أو مساهمتهم في النضال ضد عبود خلال الست سنوات التي كان فيها في السلطة. في حين أن المهنيين كان لهم دور مميز في الثورة نفسها، ولكن اتحادات العمال كانت أكثر الأجسام التي لها سجل مستمر في النضال ضد نظام عبود، وأيضاً النضال ضد الاستعمار والنظام البرلماني الذي خلفه
تخلص الكاتبة إلى أنه “ليس هناك حزب سياسي وحيد احتكر القوى الحديثة خلال الثورة”، وترى أن وضعية النقابات العمالية داخل القوى المعارضة للنظام كانت محدودة مقارنة بالمهنيين. وهذا يذكرنا بأن الثورة كانت قيادتها محتكرة في نطاق ضيق، وهو نطاق المهنيين المنحدرين من خلفيات شمالية نيلية، الأمر الذي يشير برأيها إلى أن مفهوم “القوى الحديثة” يستبعد أعداداً كبيرةً من السودانيين، ليبقى الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة القاضي عبدالمجيد إمام، الذي تعود خلفيته إلى جبال النوبة في جنوب كردفان. هو الذي قاد مظاهرات القضاة في أكتوبر 1964، ولكن بابكر عوض الله هو الذي أصبح رئيساً للقضاء بعد الثورة بدلاً عن عبد المجيد إمام الذي كان في طليعة المظاهرات
الفصل الخامس (القوات المسلحة: هل كانت في حماية الشعب؟)، تتناول فيه الكاتبة دور القوات المسلحة، وتقوم بتصنيف ثلاث مجموعات مهمة داخل الجيش: الأولى: قيادة الجيش الموالية للنظام، والثانية: تتكون من صغار الضباط الراديكاليين المنضوين تحت خلايا سياسية داخل الجيش. والثالثة: تكونت من الضباط الكبار أو الرتب الوسيطة الذين لم يكونوا جزءاً من قيادات الجيش، ولعبوا دور الوسيط بين المجموعة الأولى والثانية. وتشير إلى دور الفئة الوسيطة وليست الفئة الراديكالية، وهي التي حددت الدور الذي لعبه الجيش في الثورة، إذ كانت هذه الفئة تفهم دور الجيش كمؤسسة قومية، فلم ترضخ لضغوطات النظام أو ضغوطات الحزبيين، سواء من اليمين أو اليسار. لتقول: “كان هناك تشابه، إلى حد ما، بين تدخل العسكر في الانتفاضتين. في الحالتين لم تكن التنظيمات السياسية داخل الجيش – الضباط الأحرار في 64 والإسلاميين في 85 قادرين أو راغبين في القيام بانقلاب عسكري. ولكن استخدموا الانتفاضتين في التهيئة لانقلاباتهم بعد سنوات قليلة”. قام الضباط الأحرار بانقلاب مايو 69، والإسلاميون بانقلاب 89. لتخلص الكاتبة في هذا الفصل إلى أنه لا يمكن أن نقول إن الجيش أو الشرطة قاموا بصناعة أكتوبر أو أبريل. وإن كان الأسلوب الذي تعاملوا به مع المظاهرات حدد النتيجة النهائية
الفصل السادس (النظام الانتقالي 1964- 1965: هل كان فرصة ضائعة؟)، ترى الكاتبة في هذا الفصل أن تحديات الفترة الانتقالية أظهرت التصدع داخل الجسد السياسي السوداني، بسبب أن النخبة الراديكالية المدينية فشلت في أن تربط الغالبية العظمى من سكان الريف بأجندتها، وقد ساعد ذلك حزب الأمة أن يطرح رؤية بديلة للقومية السودانية، وبالتأكيد للثورة نفسها. رغم أن أنصاره لم يلعبوا أدواراً مهمةً في أحداث أكتوبر الحاسمة، ولكن هجراتهم الكبيرة في فبراير غيرت طبيعة ما تم النظر إليه كثورة مدينية. كما فشلت النخبة الراديكالية المدينية في تقديم أي رؤية ثورية جاذبة للجنوبيين، الذين أسسوا جبهة الجنوب، مما يعني ضمنياً أنهم مفصولون من اتحاد النقابات وجبهة الهيئات، وهذا يوضح النواقص الاجتماعية والإقليمية للمؤسسات المرتبطة بثورة أكتوبر، والتي لم تستطع تحويل شعاراتها إلى حقائق على أرض الواقع
في الفصل السابع (الفترة الانتقالية 1985- 1986 وعناد الإسلام السياسي)، ترى الكاتبة أن الفترة الانتقالية كانت مليئة بالخلافات. من جهة كان هناك خلاف بين الجيش والمهنيين، ومن جهة أخرى كان هناك خلاف بين المهنيين والأحزاب، بالإضافة لخلافات المهنيين فيما بينهم. لتقول إنه وبعد سماع كلمة سوار الدهب في 6 أبريل بانحياز الجيش للشعب، تجاهل ممثلو حزب الأمة والاتحادي الاجتماع المزمع عقده مع المهنيين، وذهبوا لزيارة قيادة الجيش لمباركة خطوتهم في الاستيلاء على السلطة، مما وفر سياقاً ملائماً للعسكر ليحلوا محلهم كقيادات للفترة الانتقالية. وقبل ذلك كانت أكثر نقاط الخلاف إثارة للجدل بين الأحزاب والمهنيين، كانت حول مدة الفترة الانتقالية. فممثلو اتحاد المهنيين طالبوا بمدة خمس سنوات للفترة الانتقالية، وكان رأيهم أن هذه المدة ضرورية لكنس كل الآثار السالبة للنظام السابق، وتأسيس قاعدة لسودان حر ديمقراطي تعددي. وممثلو الأحزاب السياسية رفضوا هذه المدة. وبعد مفاوضات مضنية قبل المهنيون بتقليلها. تقول الكاتبة: “إن المهنيين تعلموا من درس أكتوبر أن عودة سريعة للانتخابات تعني أن تأثيرهم في الحياة السياسية سيختفي سريعاً”
الفصل الثامن المعنون (انتقام مايو: ثورة الإنقاذ، يونيو 1989)، تقدم فيه الكاتبة تحليلاً وافياً لبنية نظام الإنقاذ. وتقول: “إن أكثر سبب لاستمرار نظام الإنقاذ هو التعامل القاسي مع القوى الحديثة. فمباشرة بعد الانقلاب، قامت حكومة الإنقاذ بحل النقابات العمالية الرئيسية واتحادات المهنيين واعتقال قياداتهم، ليصل عدد العمال الحكوميين الذين تم فصلهم من عملهم منذ وصول الإنقاذ للسلطة 73,640، وهو ضعف عدد المفصولين في الفترة من 1904 حتى 1989”. وفي تحليلها لدور الطلاب في مناهضة النظام، ترى الكاتبة أن القطاع الطلابي هو الفرع الوحيد من فروع القوى الحديثة الذي لم يستطع النظام السيطرة عليه
في خاتمة الكتاب، تطرح الكاتبة تساؤلات عن إمكانية نجاح انتفاضة في المستقبل، وتقول: “بالتأكيد، يمكن أن تنجح انتفاضة، دون حتى أن يتم حل الصراع بين المهمشين والأقاليم المركزية، وأيضاً الصراع بين من ينادون بتطبيق الشريعة ومن يرفضونها. وهذا ما حدث في انتفاضتي 1964 و 1985″. لكنها ترى أنه دون القدرة على تأسيس أرضية سياسية مشتركة تستوعب هذه المجموعات المتنافسة، فإن الانتفاضة الثالثة من المحتمل أن تعيد إنتاج إخفاقات الانتفاضتين السابقتين، وتؤسس ديمقراطية هشة يمكن إسقاطها بنظام سلطوي يشبه نظام: عبود، نميري، والبشير. و تشدد على ضرورة أن يتعلم أصحاب الحنين لأكتوبر وأبريل من إخفاقاتهما، وفي نفس الوقت أن يحاولوا إعادة إيجابياتهما..
نقلاً عن مدونة في المكتبة
عن المؤلف
أحمد آدمأستاذة التاريخ بجامعة نيوكاسل في بريطانيا

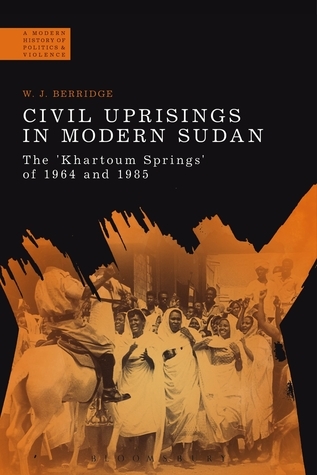
أضف تعليق